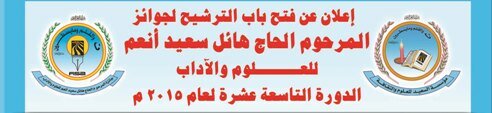حاوره: أحمد قنبر
تهمتان تلاحقه ..«الغاء الآخر».. و..«رهين مزاجه».. هو لا ينكر الأخيرة بالطبع فهو يصرح لـ«أفكار» أن المزاجية تلازمه منذ التزامه التنظيمي للحركة الناصرية, أما الأولى فقد يلحظها القارئ في حدة تقاطعه الثقافي في هذا الحوار مع الآخر ((القبيلة و«الاسلاميين التنويريين» والعراطيط «الذين تجاهل الحديث عنهم» والفنانين الشعبويين .. وملحق أفكار أيضا «الذي نصح المؤسسة بالاستغناء عنه»..))..هو طبعاً يرفض أن يسمي تقاطعه ذاك مع الآخرين – القبيلة مثلا - «إلغاءا» بل “اختلافا”.. وقد يبدو للقارئ أن الناقد الأدبي في هذه المقابلة محمد ناجي متشائماً, لكنه في الحقيقة يمارس دوره الطبيعي كناقد إنه لا يتحيز لأحد قدر ما يتحيز لنفسه الناقدة بالطبع..
*لنبدأ من مشكلة العقل العربي.. هناك من يطرح أن مشكلته تكمن في عدم تجذير سلطته.. أنت قلت في كتابك الأخير «الهويات الطاردة» أن هذا العقل مغتال عندنا كمتخيل فكيف سيبدع كواقع, كيف يمكن أن نفرق بين العقل الواقعي والمتخيل.. خصوصاً وانك استغربت محاولة الثورة على هذا العقل!!؟
ـ أولاً مصطلح العقل العربي، هو مصطلح افتراضي يتوهم أن هناك عقل عربي جمعي متماثل ولو على أساس عقل مشرقي وآخر مغربي، عقل غنوصي في المشرق وبرهاني في المغرب، وهو افتراض يقوم على المصادرة والانتقاء، ينتقي من التراث مايؤيد افتراضاته المسبقه وبالتالي فهذا النوع من التفكير الانتقائي هو أيديولوجي وليس معرفياً كما يسوق نفسه.. ثانياً: بالنسبة للعقل الواقعي والمتخيل، فأنا قصدت بالمتخيل هو ذلك العقل الذي يستقرئ مكونات المجتمع ويعمل على تنمية مكوناته على أساس تكافؤ الفرص بين أفراده، والتعامل مع قدرات الأفراد على أساس أنها رأسمال قومي يجب تنميتها لا الخوف منها ووأدها.
*اذا ما هي شروط إعادة الاعتبار للعقل؟
ـ ليس هناك شروط لإعادة الاعتبار للعقل وإنما يجب تأسيس العقل في العملية التعليمية على أساس العمل، وليس مصادرة العقل بمصادرة الشراكة سواء أكانت شراكة مجتمعية أو شراكة الطالب في العملية التعليمية، كمتلق، يفترض أن يكون متلقياً إيجابياً، والمقررات التعليمية والحياة السياسية، لاتستسيغ الشراكة لأنها مقلقة (للحق الواقعي والتاريخي) ماتسميه بالعقل الواقعي ليس سوى هيمنة للسياسي والمفتي والتاجر، وهذه الهيمنة لهذا التحالف أساسه المصلحة، رغم هيمنة السياسي على المفتي والتاجر.
في كتابك الأخير الذي أسميته الهويات الطاردة.. لماذا هذه التسمية وما علاقاتها .. أولاً: وما الذي يمكن أن يقدمه كتاب الهويات الطاردة لك إلى جانب كتاب أمين علوف «الهويات القاتله»؟ وثانياً: هل نحن نعاني من أزمة «تعدد الهويات».. في ظل التنازع حول أزمة الهوية ذاتها..(هوية إسلامية وهوية قومية ...الخ).. وهل نحن بحاجة لتعريف الهوية وصولا لتوحيدها؟ وثالثاً: ما تأثير هذا الصراع حول الهوية واحتكارها على الحاضر والمستقبل؟
ـ الكتب التي تطرقت بالتحليل لمفهوم الهوية كثيرة، والتي تناولت أشكال الاقتتال بين هذه الهويات، هي أيضاً ليس فقط كتاب الهويات الوهمية، أو كتاب الهويات القاتلة، بل أعتقد أنه رواية (ليون الأفريقي) لأمين معلوف، هي أهم من كتاب(الهويات القاتلة) في روايته مبني من خلال السرد المبني على التاريخ.. شخصية ليون الأفريقي المنقسمة قسراً بين هويتين: عربية أفريقية وأوروبية وبالتالي بين ديانتين ولغتين، هذا القسر هو الذي يؤدي إلى استلاب الهوية، فيصبح غريباً لدى كل الهويات المغلقة. ليس هناك هوية جامعة، وبالتالي هناك أزمة هوية لم يتم الاشتغال عليها ثقافياً وسياسياً منذ عام 1990م أنا أتحدث عن هوية جامعة وليس هوية واحدة، الهوية الجامعة تقوم على التوافق والاتفاق بين المختلف والمتعدد والهوية الواحدة تلغي قسراً التعدد وترى أنه خطر على الهوية الواحدة، لكن الهوية الواحدة تصبح ميتة لأنها تفتقد لحيوية التعدد والاختلاف.
*«لمذاهب الدينية مثلها مثل الأديان ترتبط من حيث الحاجة إلى النفوذ بالسياسة والحكم».. هذه عبارة قلتها في الهويات الطاردة .. وهي تثير جدلاً ما زال قائماً بين السياسي والمتدين من يحكم من؟ ومن يحتاج للآخر؟ وماهي حدود الاختلاف والاتفاق؟ وما علاقة الدين بالسياسة والحكم؟ وهل ممكن ان تتشكل نظريا على الأقل دولة مدنية في الاسلام؟
- التحول إلى الدولة المدنية يحتاج إلى تجديد في الفكر الديني، وبالتالي تجديد أدوات ومناهج الاجتهاد، ماهو موجود في الساحة اليمنية من أسماء مثل مجيب الحميدي، شوقي القاضي ومن أسميتهم في سؤالك بالاصلاحيين الجدد مثل العسالي، وعمر دوكم وغيرهم هؤلاء يتحركون كخطباء مساجد في إطار المنقولات فينتقون من هنا وهناك باحثين عن رخص لطريقتهم في الحياة، لكنهم لايختلفون من حيث المنقولات التي يستشهدون بها عن خصم لهم مثل(الحزمي) مثلاً إذاً الدولة المدنية بحاجة إلى تجديد في المناهج وآليات الاجتهاد حتى نصل إلى تجديد في الرؤى.
*أنت تصنف عدو القوى التقليدية لكنك في الهويات الطاردة ترتبط بينها وبين قوى ما بعد الحداثة؟ كيف يمكن أن يحصل التوافق بين التقليد والحداثة؟
ـ القول بأنني أصنف عدواً للقوى التقليدية هذا قول أيديولوجي وليس توصيفاً علمياً هناك فرق بين العداوة والاختلاف.. أنا أختلف معهم لكنني لست عدواً هو اختلاف على أرضية إنسانية سأضرب لك مثلاً أخي أحمد ناجي النبهاني أستطيع أن أصنفه أيديولوجياً ضمن القوى التقليدية علاقتي معه قائمة على الاختلاف والمحبة وليس العداوة. أشرت في كتاب الهويات الطاردة إلى مايجمع القوى التقليدية بما بعد الحداثة وإلى مايميز بينهما ليس هناك مابعد حداثة واحدة وإنما هناك تيارات، يمكن أن تصفها بأنها حداثة جديدة، لكن الحداثة الجديدة، لاتنمو إلا على الثورة على القوى التقليدية وتفكيك سلطتها، مايحدث اليوم في المجتمعات المختلفة ومنها اليمن، هو توظيف ثورة المعلومات وغيرها من ثورات العصر، لتعزيز هيمنة القوى التقليدية!!
{>..علاقة القبيلة بالمواطنة المتساوية تشكل حيزاً كبيراً من كتاباتك النقدية.. واتهمت بوضوح المعارضة اليمنية بفشلها في تمدين القبيلة .. في هذه النقطة هناك من يتهمك بأنك تمارس إلغاء لمكون هام من مكونات المجتمع اليمني لا يمكن تجاوزه .. وفي نفس الوقت الغاء الآخر «القبيلي هنا» يتعارض مع قيم الحداثة والديمقراطية ذاتها؟
ـ لم أقل إلغاء القوى القبلية وإنما دمجها في المجتمع كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات مع بقية أصحاب المهن، ومكونات المجتمع، بقاء الهيمنة والتمييز السياسي، يعني احتقار أصحاب المهن والتعامل معهم على أنهم في الدرجات السفلى، لهذا يحتقر القبيلي المهن لأنه مميز ولايحتكم إلا إلى طاغوت القبيلة وشيخها! التحالف بين رجال الدين ومشايخ القبائل جعل رجال الدين يتواطأون مع الأعراف القبيلية واعتبارها شرعاً، لهذا لن تتفاجأ إذا حدثت مشكلة داخل البرلمان اليمني، وتم حلها بتسليم عدد من البنادق والجنابي، ثم ذباحة ثور! حتى في قضايا القصاص والحقوق يتم حلها عرفياً بعيداً عن القانون بل وفي تناقض واضح مع القوانين والدستور. ومن المعروف أن قضية توريث النساء، المرفوضة في الأعراف القبلية، كانت عبر قرون في اليمن من القضايا التي تؤدي إلى الصدام بين القبيلة والدولة المركزية في صنعاء ستجد مثل هذا الصدام حدث في القرن السابع عشر وحدت في النصف الأول من القرن العشرين.عندما تطالب بتفكيك هيمنة القوى التقليدية، فأنت لاتلغيها وإنما تتساوى معها على أرضية الشراكة المجتمعية.
*تشكل الأسطورة مرجعاً للكثير .. كيف يمكن التفريق بين أن تصبح الأسطورة حافزاً للإبداع وبين كونها مكرسة للخرافة؟
ـ عندما تكون الأسطورة جزءاً من هيمنة تاريخية فإنها تقف ضد الابداع، وعندما ننشيء أسطورة لاتقوم على الهيمنة وإنما تعزز المساواة فإنها بالتالي تكون محفزة للإبداع. خذ المأمون كنموذج عزز اسطورة المعتزلة، للتخلص من هيمنة الغرس ثقافياً وسياسياً فكانت النتيجة الانقلاب عليها منذ المتوكل بنقيضها الذي يعتمد على النقل ولا يختلف مع السلطان الذي عززها بمبرر أنه لم يعلن كفراً بواحاً!
*الوطن الذي وصفته بالإحساس الغائب والحلم المؤجل .. البعض يعترض .. لماذا محمد ناجي متشائم إلى هذا الحد؟ هل للأمر علاقة بالذاكرة التاريخية المثقلة بالتجارب الفاشلة في خلق وطن حقيقي؟ لماذا ما زلنا نبحث عن وطن؟
ـ ليست القضية قضية تشاؤم وتفاؤل بالمعنى السطحي والعاطفي وإنما هي قضية مرتبطة بالوطن كحاجة واحتياجات لايمكن أن يكون للجائع وطن أو هوية، الجوع يسلب الانسان انسانيته بناء الانسان هو بناء للهوية الجامعة وللوطن، الجغرافيا ليست مقدسة بحجم قداسة الانسان، ماهو حاصل هو العكس. يتم تدنيس وإهمال بل وقتل الانسان لمصلحة الجغرافيا، ثم تتحول الجغرافيا إلى مجرد حفنة تراب إذا ما تعارضت الجغرافيا مع مصالح القوى المهيمنة.
{>..الليبرالية والليبرالية الجديدة والحداثة وما بعد الحداثة وو...الخ, ومصطلحات كثيرة, ظلت وما زالت تلوكها الألسن المثقفة؟ ما حقيقتها وهل فشلت لدينا؟ وهل مازلنا بحاجة للتنظير لها؟
ـ المشكلة ليست في المصطلحات وإنما في الواقع الاجتماعي نعيش في إنساق اجتماعية وعلاقات إنتاج قائمة على الاستعباد، فيصبح لدينا حالة اغتراب مع هذه المصطلحات، نحتاج إلى تطوير ونهوض للأنساق والعلاقات الاجتماعية لكن ذلك مرهون أيضاً بالارادة السياسية، وهي إرادة تخاف من المغامرة قد تؤدي بهيمنتها لكن التاريخ المعاصر يؤكد أن التخلف وتعزيزه ليس سوى مغامرة ستفقد السياسي وجوده وليس فقط هيمنته.
نعود الى تساؤل العلاقة السياسي بالديني؟
- تسأل عن العلاقة بين السياسي ورجل الدين، بين رجل الحكم ورجل الدين، هي علاقة تابع بمتبوع، يمكنك أن تقرأ وتتلمس هذه العلاقة بوضوح في العلاقة بين الأزهر ونظام الحكم في مصر طيلة القرن العشرين، أو تابعية رجل الدين للسياسة في السعودية، أو حركة الإخوان المسلمين في اليمن خلال ثلاثة عقود على الأقل ويمكنك أن تعود إلى كتاب طبائع الاستبداد وستجد الكواكبي يوضح هذه العلاقة بقوله (فالمستبد لايخاف من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد، لاعتقاده أنها لاترفع غباوة ولاتزيل غشاوة، وإنما يتلهى بها المهووسون.. لكن ترتعد فرائص المستبد من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية والفلسفة العقلية وحقوق الأم أوسياسة المدنية.. وغيرها من العلوم الممزقة للغيوم المسبقة للشموس، المحرقة للرؤوس)ص46 – مطبعة الدستور العثماني(1318هـ).
وكذلك أنظر فيما قاله توماس هوبز حيث تحدث عن رجال الدين بأنهم: (مجرد مانعة للصواعق الاجتماعية والكنيسة قوة أخرى من قوات الأمن التي تستخدمها الدولة لحفظ الاستقرار الاجتماعي لاتختلف عن البوليس والجيش في طبيعتها ولكنها أفعل منها أثراً وأوسع مدى، وربما أقل تكلفة إنها تقيم على كل انسان شرطياً ملازماً له داخله). وهو نفس ما رد به (نظام الملك) وزير الملك السلجوقي(أرسلان شاه) حين قال لمولاه لقد كونت لك جيشاً من الدعاة يدعون لك في الليل.. وهو جيش في نظر (نظام الملك) يكمل ويوازي دور جيش الدولة السلجوقية الذي يحمي الملك من الخصوم في اسيا أومصر. ألم يكن الإمام الغزالي في رده على الفلاسفة والباطنية يقوم بهذا الدور ويجسد علاقة التبعية لمتطلبات السياسة والحكم!
قدمت قراءات نقدية لبعض النصوص السردية اليمنية(مثل عقيلات وطعم اسود وبلاد بلا أسماء):
أولاً: ما هي ملاحظاتك النقدية على تلك النصوص باختصار ,وهل تشكل تلك الأعمال الأدبية تطوراً هاماً في مسيرة الأدب اليمني؟
ثانياً : هناك من يطرح أن هذه الروايات لم تضف جديداً للمشهد التسعيني؟, وإذا كانت لم تقدم جديدا ..لماذا يتراجع الأدب اليمني للوراء في رأيك؟
ثالثاً: ما الفرق بين جيل الألفية جيل التسعينات؟ وما رأيك بالرواية الالكترونية ..هل أضافت شيئاً؟
بالنسبة لقراءتي النقدية لتلك الأعمال لست بحاجة إلى إعادة ذكرها، لكن هل تشكل هذه الأعمال وغيرها من الروايات التي كتبت خلال العقدين الأخيرين تطوراً: بالتأكيد الرواية في هذين العقدين هي أهم ما أنجزه الأدب الروائي منذ بداياته وحتى الآن، لأنها روايات واكبت تحولات خطيرة على مستوى السياسة والأيديولوجيات والأعراق والاختراعات والثورات العلمية، لهذا بالتأكيد ماكتبه أحمد زين ومحمد عثمان وعلي المقري وجدي الأهدل وغيرهم هو الأهم في المنجز السردي اليمني.
هذه الروايات قدمت (الرواية الجديدة) في اليمن أكان ذلك في خطابها الروائي أم في تقنياتها الروائية، قارن بينها وبين ما أنجزه محمد عبدالولي وزيد مطيع دماج وأحمد محفوظ عمر ستجد أنها مختلفة نصاً وخطاباً.
*هناك شخصيات انت سميتها عمالقة القرن العشرين في اليمن.. هل هذا التوصيف صحيح؟ ولماذا؟
ـ وصفي للدور الريادي الذي قام به الأستاذ محمد أحمد حيدره ومحمد عبدالولي وهاشم علي توصيفي لدورهم الريادي في التربية والفنون والسرد، بأنه دور لايقوم به إلا عمالقة.
كان توصيفاً دقيقاً، وليس حكماً اعتباطياً ومجانياً، ولن يعترض على توصيفي إلا جاهل بدور الأستاذ حيدره لأن جهود هذا العملاق المسرحي والتربوي، غير موثقة باستثناء اشارات له في المذكرات، أو ماكتب عن تاريخ المسرح في اليمن، لكن الدور التأسيسي الذي قام به حيدره وأحدث من خلاله تطويراً للمسرح.. اخراجاً وتأليفاً وتمثيلاً دور يشهد به مسرح مدينة عدن في عشرينيات القرن والنشاط الثقافي لنواديها والذي كان للأستاذ حيدره ومسرحه حضور متميز وريادي في تأسيس المسرح وتطويره وماقام به في مدينة التربة من غرس القيم الوطنية، وتأسيس هوية وطنية، موازية للهوية المصرية حينها كان ريادياً وصادماً لآفاق الكثيرين وعلى رأسهم الأستاذ النعمان والحاكم المجاهد وعامل التربه، الذين قاموا بالوشاية به إلى الإمام يحيى، واتهموه بالكفر، وبأنه يقول بدوران الأرض!! ويعلم التلاميذ الموسيقى ويبذر بذور الوطنية من خلال الأناشيد، التي أتت لهم بهوية مختلفة عن هوية التعليم التقليدي، الذي يدور حول نقليات، وتعظيم مولانا أمير المؤمنين!!
نفس الأمر تجده لدى محمد عبدالولي والذي كان سارداً متميزاً في مجال القصة القصيرة والرواية، وتأثر به خلال العقود التي تلته العشرات من الأدباء، الذين ساروا على طريقته في السرد، نصاً وخطاباً، لغة ورؤية.
وأما هاشم علي هذا الانسان الذي لون مدينة تعز بلغة ضوئية استمرت لأكثر من نصف قرن، وتناسل منها العديد من الفنانين، فهل وصفه بالعملاق والرائد التشكيلي والمعلم الأول نظراً لاستمراريته وتأثيره، هل هذا التوصيف اعتباطي!!
*ماذا عن الثقافة الشفهية والكتابة؟
ـ الايديولوجيات عززت الثقافة الشفهية ومقايل القات حضانات أساسية للثقافة الشفهية الاجترارية, وأتت المواقع الالكترونية ذات النمط التعارفي لتعزز من المشافهة.. الصحافة اليمنية على الأغلب، وبسبب أنها تعمل من داخل المقايل، وليس من الوقائع هي كذلك رفد من روافد الخطاب الشعبوي.. الثقافة الكتابية ليس لها روافد موضوعية تعمل على استمراريتها، أنظر إلى المجلات الثقافية وعدم قدرتها على الاستمرار والالتزام بمواعيد صدورها: أبواب، صيف، غيمان، الثقافة.. كلها مجلات تفتقد للتراكم والامكانيات وتتعثر الرغبات الثقافية لها.. ليس هناك مايشجع على القراءة في المدارس ويتعود الطالب على إذاعة مدرسية مملة ومستنسخة يفتتحها التلميذ بشعار (لا رأسمال المغرب ينفعنا ولافوضى شيوعي سخيف «أبلدي» مع افتقاد معظم المدارس للمكتبة المدرسية وإن وجد المبنى فلايوجد الكتاب، ولاتوجد مكتبات عامة، ولامكتبات حزبية ولامكتبات في النوادي الرياضية.. تصبح الشفهية هي المهيمنة والمؤثرة في المقيل وفي المسجد وفي الحزب وفي المدرسة وفي النادي وفي الشارع، لهذا نهلل كلما وجدنا صحفياً أو كاتباً يجسد هذا الخطاب ويعيد تقديمه لنا على صورتنا.. نفرح به ونشيد به والحقيقة هي أننا نفرح بشعبويتنا وبصورتنا التي التقطها لنا ذلك الكاتب أو الشاعر أو المشخصاتي سواء أكان الكاتب فكري قاسم او المشخصاتي فهد القرني أو الأضرعي أو كان الرسام عبدالله المرور أو عبدالغني علي كلها أسماء تتجسد الشفهية بنمطيها الأيديولوجي والشعبوي عبر اللغة واللون والتشخيص.
*القراءة لدى محمد ناجي وعاداته فيها؟
ـ أقرأ في الصباح وبعد العصر وقراءاتي في الأجناس الأدبية والفكر واللسانيات وبعض الكتب العلمية في البيولوجيا والفيزياء العامة منها وفي المساء أشاهد فيلماً أمريكياً على الأغلب وأستمع إلى أغنية.. عملي مدرساً في الثانوية العامة يساعدني على ترتيب وتنظيم وقتي منذ الفجر وحتى العاشرة ليلاً.
*كونك معلماً .. وضع التعليم هل وصل الى مستوى الخطر؟
ـ القول بأن التعليم في خطر توصيف يخفف من الكارثة التي وصل إليها التعليم يكفي أن تعلم أن الكثير من مخرجات التعليم الثانوي يتجهون للتطرف والمخدرات لأنهم لم يتلقوا علماً ينمي مهاراتهم ولم يجدوا فرصاً للحياة والابداع.. وماتلقوه من نقليات ومحفوظات وممارسات في البيئة الصفية والمدرسية يعزز لديهم التوجه نحو التطرف أو المخدرات أو أي شكل من أشكال الفساد.
*لنذهب لتعز أنت اتهمت في احد الحوارات معك أن تعز لم تعد مدينة التحولا ت الثقافية, اولا : على أي اساس بنيت هذا الحكم الذي قد يعتبره البعض جائرا؟ واذا كانت كذلك حقا فهل العيب فيها أم في مثقفيها؟ ثم انه في تعز قامت العديد من التحركات الثقافية .. هناك مثلاً على المستوى الادبي “العراطيط” وعلى المستوى الإسلامي هناك من اطلق عليهم “الاصلاحيين الجدد” كـ(عمر دوكم والعسالي والبنا وشوقي القاضي و..الخ).. البعض يرى ان هؤلاء قدموا رافدا جديدا حرك الملل الثقافي للمدينة,, وانت تعتبره مجرد صراخ عال..كما في احد توصيفاتك للثقافية تقريباً؟ هل حقا هم اقل تنوراً من ياسين عبدالعزيز!!؟ ثانيا : هناك من يطرح أن «تسيس المثقف و ارتهانه للأيديولوجيا أو المنفعة الشخصية» بالاضافة الى «نرجسية الادباء» هي من أسهمت في تراجع ثقافة تعز.. الى أي مدى هذه الكلام صحيح.. وهل حقا الادباء مسيسون ونرجسيون؟
ـ تعز لم تعد مدينة التحولات الثقافية والسياسية لأنها لاتمتلك بنية تحتية للثقافة.. مدينة خالية من السينما والمنتزهات دور النشر ليس فيها مكتبة وطنية تليق بكثافتها السكانية ليس بها مسارح ولافرق مسرحية، دعك من تلك الفرق الذكورية التي تستخدم كأداة في المعارك والاستكشات السياسية مدينة تراجعت فيها الحركة التجارية مع تآكل الأرصفة التي كانت تذكرنا بوجهها المديني، مدينة التعليم فيها تعليب للعقول وأدلجة وتزييف وتعليم يعزز العنف والفساد ويغيب التفكير.. التحولات الثقافية لاتنشأ على رأسمال رمزي اسمه التراكم التاريخي فقط وإنما المواكبة المعرفية لمختلف الفنون أنظر إلى الفنون المختلفة قبل ثلاثة من العقود وأنظر إليها الآن ستجد نكوصاً، وهو نكوص مركب لأن الاحتذاء بالماضي هو نكوص بذاته فما بالك حين يصير هذا الماضي هو شاهد للمقارنة!!
*في كتابك «تحرير التحيزات» أنت تقدم نقداً للتحيزات المناطقية لكن هناك من يتهمك انك تتحيز لتعز؟ هل هذا صحيح؟ واذا كان كذلك فلماذا هذا التناقض؟
ـ لا أتعامل مع تعز على أنها عبقرية بالجغرافيا كما يسوق البعض، ولا أستسيغ المصطلحات الأيديولوجية التي تصفها أحياناً بالحالمة وأحياناً بالحليمة! هذه توصيفات شعبوية تستند إلى أوهام العبقرية، إنما هناك شروط مادية وبنية تحتية يجب توفرها لهذه المدينة وغيرها من المدن اليمنية إذا أردنا تحولات ثقافية على أساس توفر الفرص للجميع. أولاً الانتماء إلى هذه المدينة التي أعيش فيها منذ مايقارب الأربعة عقود ونصف.. الانتماء إليها وحبها ليس تهمة وإنما أمر طبيعي، وليس في ذلك تعصب وتحيز، التعصب حين ترى نفسك متفوقاً على الآخرين لأسباب عرقية أو جغرافية ولاستحقاق تاريخي تتوهمه، أما أن تنشأ بينك ومدينتك علاقة وجدانية فهذا شيء بدهي، وأنا هنا لست متناقضاً مع ماطرحته في مقالتي(تعز والهويات المتخيلة) أو (تعز والحكم الذاتي) أو (الهويات الطاردة) بل متسق معها، عندما لاتتوفر في المدينة التي أعيش بها بنية موضوعية للتحولات المعرفية سواء في الفنون أوالثقافة أو التعليم، فإنني أتأثر بالمعنى النفعي والعاطفي، لأنني جزء من هذا المكان، وتخلفه يؤثر عليّ بشكل مباشر. كذلك الاستقواء بخرافة عبقرية المكان، التي يتكئ عليها البعض في منطوقهم الكتابي ووعيهم الشفهي، أو الاستقواء بما يراهن عليه الصديق(مصطفى راجح) ويوصفه(بالكتلة البشرية) كل هذه الرهانات تؤسس للمصادرة وتؤسس كذلك على مصادرة الآخرين تحت وهم الغلبة، أكانت جغرافية أو بشرية كل ذلك من وجهة نظري يعزز الهيمنة ولايفككها!!
*ماذا عن المجتمع المدني اليمني؟ هل هو مرتهن للمادة؟ أم للعمل المدني؟
- ........................................................
*بصفتك ناقداً كيف تقدم قراءة نقدية للملاحق اليومية التي تصدرها الجمهورية؟
ـ بالنسبة للملاحق الصادرة عن مؤسسة الجمهورية: أعتقد أن المؤسسة كان يكفيها أن تهتم بثلاثة ملاحق هي الديمقراطية وفنون وملاعب أنا متحيز لملحق الديمقراطية لعدة أسباب ليس من بينها علاقة الصداقة التي تربطني بمشرف الملحق، وإنما لأن هذا الملحق يعمل بدوافع معرفية تستشرف المجتمع المدني والخطاب النسوي وشريحة الشباب، الحضور النسوي في ملحق الديمقراطية هو أهم المؤشرات على امكانية تراكم تحولات مدينة وهناك انساق اجتماعية واقتصادية أتمنى على الملحق أن يلتفت إليها بعناية ليكتمل المشهد الذي نرنوا إليه.
بالنسبة لملحق أفكار أعتقد أن دوافع صدوره سياسية، لهذا تجده محصوراً في إطار الصراع داخل تيار الاسلام السياسي وإذا تم استكتاب بعض العلمانيين فهذا الاستكتاب لايكون إلا في سياق إذكاء صراعات سياسية، وإن ألبست بحجج معرفية.
*البعض يتهمك بأنك “رهين مزاجك”.. وهذ شيئ مهم .. لكن إلى أي حد يساعدك مزاجك علىالهرب من التقاليد النقدية السائدة؟
ـ المزاجية صفة تلازمني حتى في فترة التزامي التنظيمي للناصرين، وبسببها كنت أختنق من الإلتزام بالمستويات التنظيمية، وهي صفة ستجدها شائعة لدى الكثير من الأدباء وبسببها أهرب كثيراً من الكتاب وبالنسبة للتقاليد النقدية السائدة، هي لاترى في الناقد أكثر من شارح للعمل الأدبي، وبالتالي يحضر الناقد في سياق الدعاية للعمل المنقود، وهذا من الأسباب التي تجعلني أتجنب الإكثار من النقد، والبعض ينظر إلى النقد في سياق تسديد ضربة قاضية للنص المنقود، كل ذلك وغيره من الأفهام المغلوطة تجعلني أفر من النقد، وألوذ بالصمت.
*بنظرك ما هي مشكلة المرأة المثقفة (المتوسطة الثقافة)؟
....................................................
*في ذهن الكاتب قراء معينون يتوجه اليهم أو يجب أن يتوجه اليهم لاسماعهم كلمته فمن هؤلاء القراء بالنسبة اليك؟
ـ بالنسبة لي أعتقد أن القراء الذين أتوجه إليهم بالكتابة هم أولئك الذين لايحتاجون إلى إجابات ومعارف جاهزة وإنما إلى إثارة أسئلة، وقضايا معرفية للنقاش والتفكير، بهذا المعنى أتوجه إلى قارىء نتشارك معاً في التفكيردون أن نستسلم أنا وإياه للمسلمات واليقينيات الأيديولوجية مدرسية كانت أو تاريخية أو في أي جانب من جوانب الحياة.
*البعض يصور نزول الادباء والشعراء الى الصحافة ..”أزمة”, والبعض الآخر يقول إن هذا في صالح الاديب والشاعر والقراء فما رأيك وانت تحترف الصحافة والادب؟
.............................................................
*اذا وجد أي نص أدبي في الزمن العربي الراهن شعرياً كان أم نثريا مالم يكن نصا تخريبيا من الدرجة الأولى ..مارأيك؟
ـ إذا وجد النص الأدبي المتميز فإنه سيستفزنا كقراء وكل عملية تخريب لقيم ما هي لصيقة التأسيس لقيم أخرى وجماليات جديدة، كل إزاحة مرتبطة بعملية إحلال.