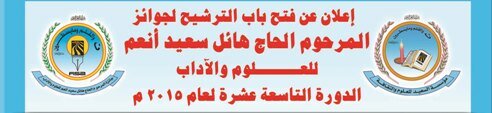محمود درويش ومرسيل خليفة علاقة الشعر والموسيقى، تناغم عميق بين القصيدة وهمس الايقاعات وأصوات الكمنجات. منجز فني قل نظيره بين شاعر ومؤلف موسيقي، وصداقة على مدى أربعين سنة جعلت خليفة يبوح للمرة الأولى بما هو عصيُّ على النسيان.
حوار: رنا زيد
هل ترى أنك حققت أسلوباً موسيقياً نهائياً في قراءة قصائد درويش؟ كيف هي علاقتك الحالية به إنسانياً وموسيقياً؟
الأمر كما لو أنه جردة حياة، شاعر، موسيقا، تاريخ، أمكنة. هي حاجة ملحة إلى أن أقول كل شيء لأتخلص من ثقل أشياء عدّة ترمي بثقلها على الذاكرة، كما على الجسد والروح. كأن سنيّ الحياة تهرب ونحاول أن نلتقطها، أن نستوقفها، نستدعي كل شيء مجدداً. كل تلك السنوات التي عشتها مع شعر درويش. لقد رغبت في نقل الأحداث والتواريخ والانطباعات. ورواية قصص تلك الأيام على نحو مفتوح. إنني لا أطمئن ولا أستقر، وأبحث كل يوم، عن جديد في شعر درويش. لا أحب أن تبقى الأشياء على هيئتها، عشقت المغامرة، لا أُجيد السباحة، ولكن غصت عميقاً في التجارب معه. مشحون بالتناقضات. رقيق مع الريح التي تلوي أغصاني. وحدها الموسيقا تحميني من القلق. شعر درويش عصيّ على الامّحاء، إذ إنه يستطيع أن يتجدد ويعيد تأليف نفسه مع الموسيقا، وتحويلها إلى أغنية.
لا يكفي أن تكون قصيدة درويش طيّعة، وحسب، هل هناك من طريقة معيّنة تخوضها مع القصيدة، لتعيد بناءها غنائياً؟
أتذكّر ملياً مسار القطار الطويل الذي حملني إلى تلك المدن البعيدة. «يقصد المدن التي غنّى فيها قصائد درويش»، لم يكن عندي متسع للكتابة. لم يكن ثمّة وقت زائد للتفرّغ للحديث. حاولت أن أرتّب ذكرياتي مع درويش. وكما تدفّقت على الورق ذكريات ضائعة يبقى عطرها حتى بعد ذبولها، كانت موسيقاي لشعر درويش تنحو في اتجاه الشكل الدرامي والتأليف الغنائي الحرّ غير المسجون في ضوابط محددة سلفاً. وهكذا لا تقطع في الطرب إنما توازن بينه وبين الاهتمام بمخاطبة وعي المتلقّي، مدشِّنة بذلك علامة مبتكرة مع الجمهور، وهادفة إلى إعادة تشكيل الذوق السائد مع عالم صوتي جديد معبّر عن معطيات جديدة، هو بناء مُقتصد وحريص على عدم الوقوع في الوسائل التزيينية والزخرفية القائمة على إغراءات السهولة. أي لحظة انتقال بالأغنية العربية من عالم الانفعال السلبي إلى مجال العقل الإيجابي. أعتبر الموسيقا جزءاً من حياتي، منذ وعيت الحياة. الموسيقا تتملّكني. لقد سلكت طريق الموسيقا خلال الشعر، ووصلت إلى حالة أن أقرأ القصيدة موسيقياً.
لقد بحثت مع درويش عن أغنية تقودنا إلى المستحيل، تُرشدنا إلى الدروب المجهولة لنبلغ سرّ الفرح. لا أستطيع أن أشرح ما كتبت من موسيقا لقصائد وأغنيات. نداء شعر درويش تشرّد في أعماق قلبي الذي دُقّ بوحشية ولا أعرف كيف أهدّئه. أبحث وأحاول القبض على الأغنية كيلا تفلت مني. إنها لعبة عبثية. صراع من أجل المستحيل. ظل وراء الاندهاش، بحث في الظلام، يوماً بعد يوم تأتي القصيدة لأنسجها من ألحان جديدة، مثل تنهيدة، مثل همسة. في «سقوط القمر»، مثلاً، أحمل قصيدة درويش في شفاه قلبي. أسدل بلذّة وشاح الصباح الندي.
هل تعني أن مجمل المعنى الموسيقي في قصيدة درويش المُغناة، هو نتاج صراع مع الحياة، صراع القصيدة واللحن، مع وجودهما الواقعي اللاحق، ثم البحث عن درويش في شعره؟
لا سبيل لديّ إلى المعنى إلا في أن أغمره في الأغنية أكثر فأكثر. أدخل في الأغنية إلى ما لا ينتهي، لأدافع عن الغامض السحري في القصيدة. لا بد من الرغبة والحسرة والقسوة والثورة والنداء والشعر والصمت والتذكر والنسيان والحب. أصابعي علّقتها على مشارف الوتر في «سقوط القمر» وروّضتها على الشهية. وكتبت لمحمود جهراً بيان الأغنيات هذه. أبحث عنه في الأغنية وفي كلّ ما لديّ من الموسيقا المعدة لتطرية الأيام الصعبة، بعد جرعتين من جرار نبيذ الحب.
لعلّه شيء من ماضٍ وحاضر جميل، شكّ ضائع في بلاد تنمو خفية بالباطون. أسهر على وقع حبر لحن الأغنيات، في العتمة أذرفه. ما أحتاجه هو كوفية عربية أمسح بها دمعاً حارقاً كالصديد. لقد تقرّحت قلوبنا من عفن القتل والدمار ومن تعب أسئلة قاحلة، إنني أشتاق إلى قصيدة محمود المبللة بالندى، لعل المكان ينتبه لأغاني الحب التي ترددت في الأفق البعيد. أغنية يشرّدها الغياب ويغسلها سحاب ليل ينام بين الأمواج، تقطفه الخناجر وتطويه زغرودة الانتظار. الألم ألاّ تغني حين تغني، وأن تنتهي القصائد إلى أقفاص. لقد وهبت القصيدة الحياة ولم تتحول الحياة إلى قصيدة. إنه أيضاً، درب قطعه شاعرنا الكبير حين حرر من نفسه المطلق.
قلت: إنك تختلس لحظة صدور أسطوانة «سقوط القمر/ 2012» التي لحّنت فيها أخيراً مجموعة من قصائد درويش، لتعلن تشابك الإرادة والحرية والفكر في ومضة موسيقية. كيف صُغت الحب موسيقياً في القصائد المغناة: «ونحن نحبّ الحياة»، و«الآن في المنفى»، و«سرير الغريبة»، و«آه يا جرحي المكابر»..؟
لم يولد «سقوط القمر» من نزوة طائشة، خرج على منوال إيقاع الحب من نار لا يوقدها حطب البراري، من نقر على وتر القلب، من غفلة صوت مبحوح، من شرشف تضرّج بالدمّ القاني، من دمعة شاهدة على الولادة. نحن نعبث لينطلق المستحيل ونكتبه على ألواح الحياة. نعبث لئلا يضيع منا الجميل وينكسر. نبحث من جديد عن المعنى. يطيب لنا الشعر كما يطيب النبيذ. إن «سقوط القمر» هو وترٌ في العود تُعذّبه النغمات، يبحث عن بياض ليهتدي بلحظة عذبة كالأغنية. وحده الحب في هذا العالم كان يفهمنا، يُقيم فينا، يُنادينا، يبني عشّه تحت حواجبنا، يحمينا من فضول المساء ومن بخار البن في الفنجان. إنه جوع إلى ليل الشهوة والنشوة والجمرة والحسرة ولسعة الريح في المساءات الشتوية. نرى أوراق التوت تتساقط عن جسد العالم. ولم نكن نشكّ في قمر الحب الذي سقط وغمر ليلنا الدامس بالفضة الصريحة.
«سقوط القمر» هذا يُلمح إلى وفاة درويش، غيابه النهائي بيولوجياً؟
أياً كان القصد، لكن محمود ذهب إلى المستقبل الذي أراده وحلم به، على الرغم من محاولات تعطيل خطواته وتفويت ذهابه الفاتن. تمرّده واضح على فساد أشياء العالم. كان سيمتلئ بربيع الشعوب لأن قصيدته تنفخ في الروح هواء الحرية. فهو شفيف كالضوء، يعبر الروح ويتركها على دهشتها في أسئلة جديدة، تحاور عميقاً الأسئلة التي تشغل وضعنا. شعره يزهّر وينتج كالأشجار أوكسجين الحياة. لم أقل له الوداع لأنني كلما هممت بنطقها في آخر مكالمة تلفونية كان يشدّني بصوته الواثق كي نتابع الحديث. كان في صوته شهية كلام، وكان في وداعي شهية صمت. كان تلفوناً قصيراً كتحية بحّارة: رافقتك السلامة، كانت هذه عبارته الأخيرة. تصبحون على وطن.
كونك منذ البداية، لحّنت من شعر درويش ما ينطق بلسان القضية الفلسطينية، منذ «ريتا، وجواز سفر/ 1976». أتتلخص علاقتك الموسيقية بالقضية الفلسطينية في جمالية قصائد درويش وعمقها، أم أن هناك رابطا آخر خفيّا أكثر واقعية؟
في مساء بعيد في عام 1964 دخلت آلة العود إلى بيتنا الصغير، بعد أن كانت آلاتي الموسيقية محصورة بالطاولات والكراسي والطناجر وعُلَب الحليب الفارغة وقصب الغزّار اليابس. كنت أرى العود في الصور، وأحياناً قليلة في التلفزيون، أسمع صوته في الراديو، ولكن أن يكون معي في البيت! كان عيداً حقيقياً يوم وصول هذه الآلة الموسيقية الساحرة. وفي اليوم التالي ذهبت مع أمي إلى منزل حنّا كرم، ذلك الدركي المتقاعد الذي يعرف القليل من النوطة الموسيقية وما حفظه من موسيقا الدرك. تابعت تردّدي إلى منزل الأستاذ مرتين في الأسبوع، حيث تلقفت خلال ثلاثة أشهر دروسه الموسيقية، وبعدها نصح أهلي بأن أتابع تحصيلي الموسيقي في الكونسرفاتوار الوطني في بيروت، البعيدة جداً في مقياس ذلك الزمن، عن ضيعتي عمشيت. ودخلت صف الأستاذ الكبير فريد غصن العائد للتو من هجرته المصرية ليدرّس في المعهد الموسيقي. كنت في السادسة عشرة من عمري آتياً من عمشيت إلى بيروت مرتين في الأسبوع لأدرس الموسيقا إلى جانب الدروس العادية. المهم أنني، أسرد هذه البداية مع آلة العود كي أقول: إنني في طريقي إلى بيروت، كنت أرى على مداخل المدينة وفي ضواحيها، المخيمات الفلسطينية وبيوت التنك، وحتى ذلك الحين وفي ذلك العمر الفتيّ، لم أكن أعرف شيئاً عن فلسطين، ولاسيما نحن أهل الجبل اللبناني. بعد حرب الـ67، بدأت أعي هذه القضية وأوليها كل اهتماماتي، فدخلت في معترك النضال مع الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية.
هل القضية الفلسطينية وحدها هي التي أثرت في موسيقاك الملتزمة، ليبدأ اختيارك المتتالي لقصائد تخص النضال الإنساني عامة، والفلسطيني خاصة، «يا علي» لعباس بيضون، «يا حادي العيس» لشوقي بزيع، «نشيد الموتى»..، وصولاً إلى غنائية تمثّل إنساناً عربياً عابراً للزمن، مقهوراً وراهناً، في «أحمد العربي/ 1984»، عن قصيدة «أحمد الزعتر» لدرويش؟
لقد تداخلت القضايا: العمليات في الجنوب، وإطلاق الرصاص على مظاهرة عمال التبغ، واستشهاد المزارع حسن الحايك، غنيت بعدها من شعر شوقي بزيع «يا حادي العيس» «المهداة للشهيد حسن الحايك». فلسطين، الجنوب، هموم الناس، مظاهرات الطلاب، الإضراب الكبير لعمّال معمل غندور،..، إذ تطورت الأمور وحدث صدام مع الدرك واستشهد العامل يوسف العطّار. قوات صهيونية تدخل العاصمة اللبنانية وتهاجم منازل القادة الفلسطينيين، وتغتال أبا يوسف، كمال عدوان وكمال ناصر. عملية «بنك أوف أميركا» إذ اقتحمت السلطة اللبنانية البنك واستشهد علي شعيب وجهاد أسعد ورفاقهما. فغنيت لاحقاً قصيدة عباس بيضون «يا علي». ثم مظاهرة صيادي السمك في صيدا، واستشهاد معروف سعد الذي كان يمشي على رأس التظاهرة، فغنيت لاحقاً «يا بحرية». كل هذا إضافة إلى العمل مع الناس في الأحياء، مع العمال، مع الفقراء، مع الشباب، من خلال الموسيقا والمسرح، أمسيات فنية أقمتها، عبّرت فيها عن حبّي للقضية والشعب والوطن. وكان «نشيد الموتى» للشاعر السوداني محمد الفيتوري الذي غنّيته وتردد على ألسنة الناس في كل هذه الأماسي. مهرجان جبيل، أيضاً، كان تجربة رائدة حيث قدمت أوبريت «مرق الصيف» سنة 1971. كما شاركت في المباراة العربية السادسة للإنتاج الموسيقي التي نظّمها المجمع العربي للموسيقا في تونس 1973. وكنت من المتخرجين الأوّل في الكونسرفاتوار. ولم يمنع ذلك من أن تفوز مقطوعتي «سماعي بياتي» إلى جانب مقطوعتين من تأليف أستاذيّ، «سماعي نهوند» لنجيب كلاب و«بشرف عشاق» لعبد الغني شعبان.
في عام 1974 شاركت في احتفالات جماهيرية للعيد الخمسين للحزب الشيوعي اللبناني إذ قدّمت قصيدة الشاعر حبيب صادق «أرض الجنوب»، وعشت أجواء شعر المقاومة الفلسطينية الذي أعطاك زخماً، وما لبث أن وجد طريقه إلى موسيقاك وغنائك، كل هذا كان تمهيداً لتلحينك اللاحق قصائدَ درويش، ما الذي جعلك تهتدي إليه، إلى قصيدته؟
أعود بذاكرتي فأتذكر يوم السبت 12 نيسان في عام 1975، حين خرجت من مسرح قصر الأونيسكو في بيروت فرحاً من عمل كركلا الرائد «عجائب الغرائب»، وكنت قد كتبت الموسيقا لهذا الاستعراض الكوريغرافي الأول لعبد الحليم كركلا. ولكن الفرح لم يكتمل، في اليوم الثاني، 13 نيسان، وبعد الحفلة، خرجنا من القاعة وكانت بيروت قد دخلت في الظلام وأصيبت العروس في الاستعراض أميرة ماجد، الراقصة الأولى، برصاصة قنّاص اخترقت ظهرها وأقعدتها مدى الحياة بعدما أضاءت في الليلتين عوالم الفرح في قصر الأونيسكو. عدت ليلتها إلى قريتي عمشيت منكسراً وحزيناً. كل شيء كان قد تعطّل في البلد وابتدأت الجولات الحربية العسكرية الجديدة علينا. ثمّ بدأت مظاهر الحرب تكسو قريتي الهادئة. مسلحون يروحون ويجيئون. انقطعت الطرقات، وانقطعت عني أخبار بيروت، وانحجزتُ في منزلي قسرياً ولم يكن معي في خلوتي هذه سوى العود وبعض دواوين محمود درويش، رحت خلالها ألحّن القصائد الأولى لمحمود درويش. ثمّ بعد فترة حزمت أمتعتي وأمري وذهبت إلى باريس هارباً من عمشيت مع كوكبة من الأصدقاء إذ لم تتحمّل المنطقة ميولنا اليسارية. والتقيتُ في باريس بالأصدقاء الجدد الذين غصّت بهم المقاهي، وبحلقات من الشباب الوافدين حديثاً أو المقيمين بداعي الدراسة أو بداعي السياسة. مجموع هذه اللقاءات كوّن مناخاً اجتماعياً وفنيّاً وسياسيّاً حاراً تزكي طراوته الأحداث المتسارعة التي كانت تجري في لبنان، والتي كانت تأخذ طابعها الدراماتيكي المعروف. رحت بخجل وتردّد أعرض بعضاً من تجاربي الموسيقية الشعرية الأولى. شاب متحمّس أخرق يريد أن يجعل الموسيقا سبيلاً لتغيير العالم، أن يخفف الألم والبؤس والفقر والحروب. أن يشعل ثورة مدعوماً بوتر العود والقصيدة الجديدة ليستدلّ على الحلم ويصل إلى تحقيقه. كان الأصدقاء الجدد يسمعونني ويهزّون برؤوسهم. ربما لم يدركوا يومها تماماً ما هو مشروعي. أو على الأقل جدّية ما أحاول الخوض فيه. وكان داخلي مشحوناً بالتمرّد وكان الزمن يمشي بطيئاً وكنت أستعجله لأكبر.
هل استأذنت درويش قبيل تلحين قصائده؟ هل اتفقتما على طريقة للخروج بالقصيدة إلى عامة الجمهور؟
في صباح باكر من شهر آب من سنة 1976 دخلت إحدى أستديوهات باريس الصغيرة، وسجّلت «وعود من العاصفة» أولى أغنياتي لقصائد محمود درويش قبل أن أتعرّف عليه شخصياً. وكنت أعتقد أن هذه القصائد ملكية عامة، ولا ضرورة لإعلام الشاعر بنيّة التلحين. وبعد أخذ وردّ مع مسؤولي شركة الأسطوانات الفرنسية «الغناء في العالم» ظهرت الأسطوانة الأولى في احتفالات جريدة «الإنسانية». وكانت أول تظاهرة لهذا العمل على خشبة الجناح اللبناني في الـ«كورنوف» في ضاحية باريس الشمالية بقرب من بسطة للحمّص والفول والفلافل. ولقد تضمّنت هذه الأسطوانة أربع أغنيات من شعر محمود درويش هي: «وعود من العاصفة»، «إلى أمي»، «ريتا»، «جواز السفر»، وأغنية «جفرا» للشاعر عزّ الدين المناصرة. ولقد وقّعت على أكثر من 500 أسطوانة خلال يومي التظاهرة، ثمّ سبقتني الأسطوانة والأغنيات إلى بيروت، ومن ثمّ إلى كلّ المطارح. ولم يخطر في بالي أبداً أن هذا اللعب سيصبح جديّاً إلى هذا الحدّ.
إذاً خضت تجربة التلحين من دون العودة إلى درويش، متى كان اللقاء معه؟
اللقاء الأوّل مع محمود درويش كان بعد عودتي من باريس وكان لقاءً حميمياً، دخلنا في حديث الموسيقا والشعر، وليس هناك ما هو أكثر بداهة من الكلام عن الموسيقا أو الشعر في حضرة محمود درويش.
كيف تضمّن بقاء القصيدة ضمن كينونتها اللغوية التقليدية مع تلحينها؟
ما فعلته في قصائد محمود درويش كان محاولة جدية لأن تبقى الموسيقا أوّلاً عنواناً للمشروع، ومن ثمّ تصدر عنه البطاقات الأخرى. كان محمود نبيلاً ومفعماً بقلب كبير، اقتربت منه ومن روحه، واتسعت موسيقاي لشعره. تأتي قصيدته بكامل سطوتها لتتحرّك مع إيقاعي وتملأ الفضاءات. بعد الخروج الفلسطيني من بيروت في عام 1982، في ذكرى التضامن مع الشعب الفلسطيني التقيت محمود درويش في قاعة الأونيسكو في باريس. حفلة ثنائية بين الشعر والموسيقا. كان السيل يأخذ من العيون المطلّة في الصفوف المتراصّة التي تنتظر دورها لتدخل، حدّق محمود في عينيّ بحنان قبل بدء الأمسية وكأننا في بيروت نستعيد أيامنا هناك. ولقد سمعت خفقان قلبي المفعم بالحب والمستعصي على الوصف. تلا يومها قصيدة «سلام عليك وأنت تعدّين نار الصباح»، وتابعت بعده: «أحنّ إلى خبز صوتك، أحن إليك يا أمي».
ما شكل علاقتكما الإنسانية؟ وما شكل علاقته بأغنياتك الملحّنة عن قصائده؟
لقاءات باريس الاستثنائية كانت نسمات للصداقة والأمل والشعر والموسيقا، وكان محمود قد انتقل إلى باريس للعيش فيها. التقينا كثيراً هناك في هذه المدينة الساحرة. كان يحب الأطفال ويتابع باهتمام دراسة ولديّ رامي وبشار الموسيقية، ولن أنسى كيف كان يحضنهما بكلتا يديه حين يعزفان له مقطوعات لشوبان ولموزار. وكان يدور الطرب ويطلب منّي دائماً أن أسمعه «في البال أغنية» وكان يحب هذه الأغنية كثيراً. أخبرني مرة في جلسة حميمية عن أمّه، إذ كان يعتقد أنّها لا تحبّه لأنها كانت تؤنّبه دائماً وهو صغير، ولاسيما على شيطناته في تلك الطفولة الزاهرة. كانت ترغمه على أخذ ملعقة زيت الخروع ذات المذاق المرّ. ولقد أحسّ بحبّ أمّه عندما سُجن للمرة الأولى. وكانت «حورية» تزوره وتحمل له السكاكر والأكل. فكتب على علبة الدخان قصيدة «أمّي». وأنهى خبريّته متوجّهاً لي: «قصيدة أمي التي حوّلتها حضرتك إلى نشيد وطني يتردّد على كل شفة ولسان».
ما مدى تنوع علاقتكما كشاعر وموسيقي، وكمتلقٍّ للشعر ومستمع للموسيقا؟
في أمسية قرطاج في تونس أمام ألوف المستمعين ينشدون صامتين. كان محمود حاضراً في الأمسية الموسيقية مع خمسة عشر ألف متفرّج. وفي اليوم التالي من تلك الحفلة الشهيرة حضرت أمسيته الشعرية، وكنت جالساً في الصف الأمامي فرحّب بي معلّقاً: «نرحّب بشاعر الأغنية مرسيل خليفة»، وعلا التصفيق في الصالة. ثم كان ذهابنا الفاتن إلى أسواق العاصمة القديمة، وتلك الدكاكين المكدّسة ولافتاتها المزركشة وشعاراتها الفضفاضة. رائحة الصابون المخلوطة بعفونة الحبوب، وتلك الأوعية الزجاجية الملأى بالسكاكر من جميع الألوان والأشكال، ومعها أكياس الخيش المملوءة بالسكر والملح والأرزّ، ورائحة الحنّة الفوّاحة والطحين والزيت والزيتون، وتلك الأبواب الخشبية المدعومة بقضبان الحديد الطويلة، والناس من كلّ حدب وصوب يدعوننا للدخول إلى الدكاكين، يأخذون الصور التذكارية، وفرح عامر يسيطر على الوجوه.
هل حدث أمر آخر، بعد ذلك النهار، عمّق اللقاء الإنساني؟
في المساء دعانا أبو عمّار إلى مائدته. كانت العاصمة التونسية نائمة ومغسولة بالماء والظلام والهمسات. حُراسّ وسيارات أمن يقتربون منّا، وفي يد كلّ منهم بطّارية ينير بها الظلام، ولا تمرّ سيارة إلا بعد الاطلاع على تصريح خاص يحمله سائقها. دخلنا البيت، وأوّل ما طالعنا وجه أبي عمّار وتلك الابتسامة التي تعطي الانطباع بالصبر. أخذنا بالأحضان كعادته وبالقبلات. وكان المصوّر حاضراً فبدأ بأخذ الصور التذكارية. وفي مثل هذه اللقاءات من الصعب أن يجد الإنسان بسهولة نقطة البدء بالحديث على مائدة العشاء. فالتقط محمود ذلك. أبو عمّار يشرب الماء، ونحن بدورنا نشرب معه الماء. وبدأ الكلام إذ رمى محمود حجراً في الماء ورسم الدوائر في ماء الكلام. كان لمحمود قدرة على اجتراح النكات، وقدرة على السخرية من كل شيء.
هكذا وصلت معه إلى أقصى حالات التواصل الممكنة. ما العمل الذي ترى أنه كان متوّجاً لهذا الوفاق الإبداعي؟
بعد لقاءاتنا الباريسية في مقهى «الديك» في ساحة التروكاديرو، وحماسة محمود المطلقة لإنتاج غنائية «أحمد الزعتر»، ولقد أطلقت على العمل لاحقاً اسم أحمد العربي. أصدرت الأسطوانة، وحقق العمل انتشاراً كبيراً، ونقلة نوعية في علاقتي بقصيدة محمود درويش.
هل فيما حقّقته من مقاربة موسيقية حداثية في نصوص درويش المُلحّنة، أوجهٌ من الصحة والخطأ؟
على مسار تاريخ طويل من القصائد والأغنيات والموسيقا، منذ وعود من العاصفة، مروراً بأعراس تصبحون على وطن، وأحمد العربي، وتقاسيم، إلى سقوط القمر، كان هذا التلاحم الدافئ بين القصيدة والموسيقا؛ وفي كل عمل كنت أتعلّم كيف أحمي الموسيقا من الفضيحة والقصيدة من الابتذال؛ لأننا خاطبنا في الناس إرادة الحياة والعطاء، وحاولنا أن نسمو بالجمال إلى حيث يؤثث الناس وطناً بديلاً منه، يعوضهم عن حرمان الوطن.
إنه تجريب يستثير حاسة التأمل، بعد حوار بين الموسيقا والقصيدة، وبين صور الحياة، من جهة أخرى، التأليف المتنوع أنتج بساطة الموسيقا وعذوبة الشعر؛ في كل عمل جديد كنت أبدأ من الصفر؛ كما لو أنني لا أعرف شيئاً؛ وكل محاولة كانت قفزة في الظلام، في كل مرة كانت الأغنية والقصيدة تخلقان الشك وتدعوان إلى مراجعة الذات، كانت مشاغبة غريبة، فاجرة وصادقة، وقيمتها في تمرّدها، لقد ارتكبنا أخطاءنا الفاتنة، وكان ذلك من شروط العملية الإبداعية. كنت دائماً مع الموسيقا والقصيدة التي شكّلت فعل مشاغبة، عصياناً وجودياً، نزعة إلى الإفلات من القطيع، ودعوة إلى المستمعين لارتكاب الشغب نفسه، صرخة جريئة من أجل الحرية للاشتباك مع هذا الدوران المدهش الذي يحدث في العالم، ولقد انخرطنا فعلياً ومنذ زمن بعيد في الشغب الذي لا بدّ منه، وتمكّنّا من المساهمة في طرح الأسئلة والتعبير عن الواقع، وخلق الحوافز من أجل التغيير في وعي حركة المجتمع والناس، وليس ارتباط القصيدة والناس ببيئتها وبالظروف الاجتماعية الجديدة وبازدياد الوعي، هو ما يُطوّرها، بل قدرتها على الاغتناء من مجمل الفكر والتكنولوجيا، الذي تخلقه تقاليد أخرى مختلفة جداً، في بعض الأحيان.
سنوات طويلة ارتبطت موسيقاك خلالها بشعر محمود درويش، إذ تآلفت أعمالك في ذاكرة الناس، حتى صار اسم أحدكما إن ذُكر اسم الآخر، لِمَ في رأيك؟
كلّ محطّات مساري الموسيقي مملوءة بالإشارات إلى شعر درويش بدءاً بـ«وعود من العاصفة» ووصولاً إلى «سقوط القمر». أحسست بأن شعر درويش قد أُنزل عليّ ولي، فطعم خبز أمّه كطعم خبز أمّي، كذلك عينا ريتاه، ووجع يوسفه من طعنة إخوته، وجواز سفره الذي يحمل صورتي أنا، وزيتون كرمله، رمله وعصافيره، سلاسله وجلادوه، محطاته وقطاراته، رعاة بقره وهنوده، كلّها كلّها سكناها في أعماقي. فلا عجب إن آلفت موسيقاي أبياته على نحو طبيعي، دونما عناء أو تكلّف. يقيني أن شعره كُتب لأغنّيه، لأعزفه، لأصلّيه، أذرفه، أحكيه ببساطة على أوتار عودي.
وكالطفلين اللذين ما زالا في دواخلنا، ركض كلٌّ من الغناء والشعر على الدروب الخمسة المسطّرة في ورقة الموسيقا، مع العبث في مخبأ النوطة، أو في أرجوحة الكلمة، وراء الصوت، في العشب والريح، في الضحكة والأنّة، على حافة نفس، أو خلف لحظة قابعة في سطوره قلّما ترتادها أقواس الكمنجات وهمس الإيقاعات. أوكل للمساحة الصوتية مهمّة قول التناغم العميق ما بين الشاعر والموسيقي نابضةً دافئةً، واضحة، صوب ذرا النوى وكلّ النهوند المتنظر.
شيء كزهرة هوّة أتطاول إليها بيدي منذ زمن ولا أتجاسر. أعمالي مهداة إلى من تجرّأ وقطف الزهرة، إلى محمود درويش، فمازال صدى تلك الأيام العابرة يحلّق بي وبه على غيمة بيضاء في بيروت، في الناصرة، في باريس، في دمشق، في الجزائر، في تونس، في الرباط، في عمان، في نيويورك وفي الطريق إلى القدس..، في الزهرة الطالعة من جرح الصخرة، في الجلسة، في السهرة، في الحفلة، في الفندق، في المقهى، في الساحة، في الطائرة، في السيارة، في كل شيء، كل شيء، كل شيء.
في العام 2007، حصلتَ على جائزة أكاديمية «شارل كروس» عن عمل «تقاسيم/ 2007» المُهدى إلى محمود درويش، والمستوحى من أشعاره، أي إنها تحية عارمة أيضاً للشاعر قبيل وفاته، على مسرح راديو فرانس، ماذا تقاسمتما سوى ذلك إبداعياً؟
في الذكرى الخمسين لنكبة فلسطين جاء محمود إلى بيروت وقدّمنا أمسية مشتركة في قاعة الأونيسكو. ألقى جداريته وقدمت تقاسيم. وكانت أمسية رائعة. وفي اليوم التالي ذهبت مع محمود إلى مخيم صبرا وشاتيلا لوضع باقة من الورد على أضرحة الشهداء. كما كان الحدث، في عام 2002، بتكريم محمود درويش كأهم شاعر معاصر في العالم العربي بجائزة «لينون» الأميركية في جامعة فيلادلفيا. وقد دُعيت إلى المشاركة في هذا الاحتفال لدوري في إيصال شعر محمود درويش إلى العامة وجعله في متناولهم، وقد قدّم الاحتفال المفكّر الفلسطيني العربي إدوارد سعيد، وفي عام 2005 مُنحت لقب فنّان الأونيسكو للسلام، وكان محمود إلى جانبي فرحاً بهذا اللقب.
ماذا عن اليوم، بعد انفصاله المادي عنك، كيف تصنع العلاقة من جديد؟
البارحة، كانت الحفلة صاخبة في تطوان. كان عزفاً مباشراً على الوتر، ألقيت نفسي في غيم روحه، على صداقة أعلى من الشمس سطوعاً. كان عزفاً مباشراً على وتر النوى في صدر العود وزنده، ريشة وأصابع تتحدان في الآه وفي أريج الحب. وفي مثل ذاك المساء العاصف بالناس والموسيقا، في ذاك المسرح المفتوح على السماء، وحيث كان علينا أن نكمل سهرتنا، وننتشي بأجمل حب وبقصيدة لا تنتهي برشفتين، كنت وحدي ثمّ وحدي، آه يا وحدي عند سقوط القمر.
جردة حياة
حين اقترحت إجراء حوار مع خليفة عمّا لحّنه من شعر درويش، أجابني قبل أي شيء: «لن يكون موضوعاً متخصصاً عن الشعر والموسيقا، وإنما انحناءة حب لمحمود، شخصية وخاصة، وليست دراسة تحليلية»، وتابع: «سأقص عني البريق المبهر، وأدع وشاحي منسوجاً من تلك الخبريّات الناعمة، القديم جديد والجديد قديم أحمله بين ذراعي، ولا أخجل بمعاودة سرده». بعدها مرّ وقت، وخليفة يستدعي، بمزاجه، ما سماه «جردة حياة» مع محمود درويش وشعره؛ لذا كانت إجاباته هنا كمثل: «بساطة الحياة التي تهرب، ونحاول أن نلتقطها شعراً وتواريخ وأمكنةً»، إن خليفة يبوح كموسيقي بأنه لا يستطيع أن يشرح ما كتب من موسيقا لقصائد درويش، ولكنه حاول على مدى يومين أن يُجيبني عن بعض ما يُلحّ.